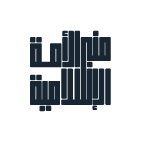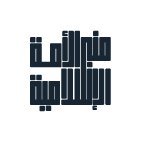تشخيص الواقع عند الجماعات الإسلامية
نشأت حركات إسلامية متعددة خلال القرن الماضي، واستهدفت أمراً رئيسياً وهو: إقامة الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية، لكنها لم تستطع ذلك، فلماذا لم تستطع تحقيق ذلك الهدف؟.
هناك أكثر من سبب حال دون تحقيقها ذلك الهدف، لكن أبرز هذه الأسباب هو خطؤها في تشخيص الواقع المحيط بها، فالإصابة في تشخيص هذا الواقع مفتاح النجاح، والخطأ في تشخيصه هو السبب الأكبر في عدم تحقيق ذلك الهدف، ونحن سنستعرض تشخيص الواقع عند بعض الجماعات لنؤكد ما نذهب إليه.
أولاً: الإخوان المسلمون
أنشأ البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، وكان هناك أمران يدخلان في تشكيل واقع مصر آنذاك هما: القومية المصرية، والديمقراطية، فبماذا حكم حسن البنا عليهما؟ عندما تعرض البنا لموضوع القومية المصرية اعتبر أنه إذا كانت القومية تعني حب القوم، والوطنية تعني حب الوطن، فهذا مما يقره الإسلام ويعترف به، وإذا كانت القومية والوطنية تعنيان التعصب المقيت للقوم والوطن فهذا مما يبغضه الإسلام، وما قاله البنا صحيح، لكن القومية المطروحة في مصر آنذاك والمنقولة عن الحضارة الغربية لم تكن المعاني السابقة فقط، بل كانت تعني أن الشعب المصري يشكل أمة فرعونية مستقلة، لا علاقة لها بالعرب والمسلمين إلا علاقة الجوار، والقومية المصرية هي الرابطة التي حلت محل رابطة الأخوة الإسلامية، والقومية المصرية هي أيدولوجيا حلت محل الدين الإسلامي، فيجب أن يكون المصري ولاؤه لمصر، وحبه لمصر، وتضحيته في سبيل مصر… إلخ، وقد قاد هذا التيار في مصر معظم المفكرين البارزين من أمثال: سعد زغلول وطه حسين وعباس محمود العقاد وتوفيق الحكيم ومحمد حسين هيكل وسلامة موسى… إلخ.
هذه القومية التي كانت موجودة في مصر آنذك كانت أيدولوجيا تريد أن تقوم مقام الدين ورابطة الدين الإسلامي، فهي غير مقبولة شرعا، وكذلك غير صحيح موضوعيا أن هناك أمة فرعونية، فالشعب المصري يشكل جزءاً من الأمة الإسلامية، وقد دخل الإسلام في كل جزئيات حياته النفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والفنية والسياسية… إلخ.
وأمر آخر لم يوفق فيه حسن البنا إلى الصواب هو تمييزه بين الدستور والقوانين، واعتباره أن الدستور المصري أقرب ما يكون إلى الإسلام، ولا يعدل به نظاماً آخر، واعتباره أن الخطأ هو في القوانين المخالفة للإسلام مثل القوانين التي تبيح الربا وتسمح ببيع الخمور وبالزنا… إلخ، لكن هذا التمييز غير صحيح لأن كلاً من الدستور والقوانين مرتبطان بالديمقراطية التي هي مظلة لهما، وهي الأصل الذي يتفرعان عنها، والحقيقة أن المخالفات الشرعية التي برزت في الحياة المصرية والتي تجسدت في القوانين المصرية، إنما جاءت من الديمقراطية التي أفرزت الدستور والقوانين، وجاءت خاصة من الجانب الفلسفي في الديمقراطية، لأن الديمقراطية ذات جانبين: الفلسفة وهي الأهم والثابت، والآليات وهي الأقل أهمية من مثل إجراء الانتخابات وإقامة الأحزاب… إلخ، والفلسفة في الديمقراطية تقوم على عدة قواعد، هي: الفردية، والمادية، واستهداف اللذة والمنفعة والمصلحة، ونسبية الحقيقة، وكل قاعدة من القواعد السابقة فيها من الطامات ما لا يحصى على الفرد والدين والأمة، مما لا مجال لتفصيله في هذا المقال.
ثانياً: حزب التحرير
اعتبر حزب التحرير أن الحكومات العربية حكومات كافرة لأنها تحكم بأحكام الكفر، واعتبر أن واجب المسلمين هو إعادة الخلافة، واعتبر أنه يجب ألا يصرفهم صارف عن هذا الواجب من مثل الانشغال بالأعمال الخيرية وجمع الأموال للفقراء، أو الانشغال بالجهاد في فلسطين… إلخ.
فكل هذه الأعمال سيقوم الخليفة بها عندما نوجده، واعتبر أن الانشغال بهذه الأعمال يعطل قيام الخلافة والخليفة ويكون على حساب القضية الكبرى وهي إعادة الخلافة، وهو ينطلق في تصرفاته تلك من أن الإسلام مر بمرحلتين: مكية ومدنية، ففي المرحلة المكية أوجد الخلافة والخليفة، وفي المرحلة المدنية أقام الجهاد، وجبى الزكاة وسد حاجة الفقراء وحصن أخلاق المجتمع…إلخ، وكذلك علينا أن نتبع الخطوات نفسها، فنركز على قيام الخلافة والخليفة، ثم يأتي تطبيق بقية التشريعات… إلخ.
ليس من شك في أن مثل هذا التقسيم ينطلق من فهم خاطئ للمكي والمدني، فالمكي والمدني هو أحد علوم القرآن الذي يقسم الآيات والسور بحسب نزولها من أجل فهمها وتحديد صفاتها، والاستفادة من ذلك في تفسير القرآن الكريم، ويتأكد الخطأ عندما نعلم أن مرحلة مكة لم تتنزل فيها أحكام العقيدة فحسب، بل نزلت فيها أحكام شرعية أخرى كانت أصولاً لكل الأحكام الشرعية التي نزلت في المدينة، فالمرحلتان متكاملتان، ولو أخذنا مثالاً على ذلك: الزكاة والجهاد، وهما تشريعان مدنيان لا جدال في ذلك، ولكن أصولهما كانت في مكة، الأول في تشريع الأمر بالصدقة، والثاني: في تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد فصل ذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب “الموافقات”. وفيي المقابل لم يتوقف البناء العقائدي في المرحلة المدنية، فالآيات التي تتحدث عن صفات الله وعن الجنة والنار أكثر من أن تحصى، وهي من قضايا المرحلة المكية.
ثالثاً: جماعة الجهاد في مصر
أبرز عبد السلام فرج في كتابه “الفريضة الغائبة” أمرين: الأول: كفر الدول القائمة حالياً لأنها تحكم بقوانين وضعية، ولا تحكم بما أنزل الله. والثاني: إيجاب الجهاد على المسلمين باعتباره الوسيلة الشرعية الوحيدة القادرة على التغيير. وقد استتبع هذا الحكم بالكفر على الدولة المعاصرة العودة إلى أحكام “دار الإسلام ودار الحرب” واعتبار أن بلادنا تعتبر دار حرب، وأعلنت بعض الجماعات الجهادية السلفية في مصر والجزائر وغيرهما إعمال أحكام دار الحرب في الواقع المحيط بها من إباحة سرقة الأموال، وسفك الدماء، وقتل الذريات… إلخ.
لكن هذه الجماعات جهلت أو تجاهلت أن أحكام “دار الإسلام ودار الحرب” إنما هي أحكام فقهية ارتبطت بوجود دار للإسلام، والآن ذهبت دار الإسلام، وذهب الخليفة الذي يقود دار الإسلام، وقد انتهت بالتالي أحكام دار الحرب، فلا يجوز استحضار أحكام “دار الحرب” دون وجود “دار الإسلام”، والمطلوب الآن إيجاد الخليفة والأحكام الإسلامية لتوجد بوجودهما دار الإسلام، ثم يمكن إعمال أحكام “دار الحرب ودار الإسلام” إذا شاء الخليفة ذلك.
رابعاً: الجماعة الإسلامية في باكستان
أنشأ أبو الأعلى المودودي الجماعة الإسلامية في باكستان عام 1941، وكانت الهند تعيش آنذاك مخاض ولادة دولتين: باكستان والهند، وكان أبو الأعلى المودودي قد أصدر عدة دراسات حكم فيها بالكفر على الديمقراطية والقومية وأنهما مخالفتان للإسلام، وأفتى بكفر الدولة الهندية، وأفتى بعدم خوض الانتخابات ضمن الأكثرية الهندوسية لعدم جدواها، كما حرم العمل في أجهزة الدولة الهندية… إلخ.
وعندما انفصلت باكستان عن الهند، وقامت دولة باكستان لحماية المسلمين، كانت قيادتها تتكون من الرابطة الإسلامية بقيادة محمد علي جناح، وكانت هذه القيادة علمانية أتاتوركية متغربة في أفكارها وأسلوب حياتها، وقد أبرز أبو الأعلى المودودي ذلك في أكثر من موضع من كتاباته، ثم قام أبو الأعلى المودودي بحملة إعلامية من أجل أسلمة الدستور الباكستاني، وكان ذلك عن طريق إعلان مبادئ ستة، ركز أحدها على أن باكستان مملكة إسلامية تحتكم إلى الشريعة الإسلامية.
وفعلاً نجح هذا الإعلان، وأخذ موافقة أغلبية المجلس التأسيسي في باكستان في 25 مارس/آذار 1949، واعتبر أبو الأعلى المودودي أن باكستان تحولت منذ تلك اللحظة إلى دولة إسلامية، تجب الطاعة لها، لكنه تجاهل أن القيادة التي وصفها بالسلوك الغربي، وباحتساء الخمور، وبالافتتان بالحضارة الغربية، وبالإعجاب بكمال أتاتورك… إلخ، تجاهل أن هذه القيادة ما زالت على رأس السلطة، فكيف سيتأتى لمن لا يؤمن بالإسلام ولا يدين بقيمه أن يطبقه؟.
لا شك أن هذا مستحيل، فالدين الإسلامي لا يمكن أن يطبق إلا من خلال قيادات مؤمنة به، متخلقة به، متفاعلة معه، ملتزمة به. لا شك أن أبا الأعلى المودودي أخطأ في تشخيص الواقع عندما لم يربط بين تغيير الدستور الباكستاني وبين تغيير سلوك القيادة التي تحكم باكستان آنذاك إلى سلوك إسلامي،لأنه هو الشرط الآخر الذي يجعل الوضع إسلاميا.
استعرضنا فيما سبق تشخيص الجماعات الإسلامية للواقع، ووجدنا أن الخطأ جاء لعدة أسباب، منها: عدم فحص المدلولات الغربية فحصاً دقيقاً مثل الديمقراطية والوطنية، ومنها: إنزال أحكام فقهية ومراحل تاريخية على غير واقعها مثل “دار الحرب ودار الإسلام” ومثل “مرحلة مكية ومرحلة مدنية”، ومنها: نقل الحكم بكفر الدولة لأنها طبقت قوانين وضعية إلى الحكم بكفر المسلمين، وهذا نقل لا يبيحه الشرع، ولا فتاوى العلماء المعتبرين… إلخ.
والآن: ما هو التشخيص السليم للواقع الإسلامي؟ لقد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمور في حياته: الفرد المسلم، والأمة، والدولة، لكن الدولة سقطت في عام 1924، فبقي أمران: الفرد المسلم والأمة المسلمة، وجاءت دولة وطنية وقومية حكمت بغير ما أنزل الله فطبقت أحكاما وشرائع كفرية، لكن هذا الكفر لا ينسحب على الفرد المسلم والأمة المسلمة، فبقي الفرد المسلم مؤمنا بالإسلام يحمل بعضا من العلم عن الإسلام، ويجهل بعض الأشياء، ويحمل تقديرا وحبا وولاء لكل مقدسات الإسلام ورجاله، لكنه يقع في بعض المعاصي والمغريات، ويتعرض للتشكيك في كثير من عقائد الإسلام وثوابته، كما يتعرض لحملات قوية لدفعه في اتجاه التغريب.
لذلك يجب على الدعاة المسلمين والجماعات الإسلامية أن تحتضن هذا الفرد المسلم لأنها ترتبط معه برباط أخوة الإسلام والإيمان بالله تعالى، فعليها أن تزيد علمه الديني، وتدفع عنه الشكوك التي يبثها أعداء الأمة، وتوضح له مخاطر التغيب وتتواصل معه وتجتهد في دفع المرض والفقر، وتساعده على تحقيق حياة كريمة عزيزة من خلال التعاون الإيجابي بينه وبينها، لذلك لا يمكن أن تتجه إلى سرقة أمواله أو سفك دمائه.
أما عن الجانب الجماعي فهناك أمة مسلمة، متمسكة بالإسلام على وجه العموم، وفخورة بهذا الإسلام، وهذه الأمة تقوم على وحدة ثقافية، ووحدة شعورية، ووحدة تقاليد وعادات، ووحدة آمال وآلام… إلخ، وهذا الجانب الجماعي المتمثل في الأمة الإسلامية يشكل رصيداً كبيراً للدعاة المسلمين والجماعات الإسلامية تستند إليه في مواجهتها للحكومات الظالمة وأباطيلها، كما تستند إليه في مواجهتها لمشاريع الدول الغربية التي تستهدف هذه الأمة بالتغريب والتفتيت والإفقار والاستغلال، والتي تدعم باطل إسرائيل على حساب حقوق الأمة الإسلامية في فلسطين وغيرها.
وإذا اضطر الدعاة المسلمون والجماعات الإسلامية إلى أن تحكم بالكفر على أحد، فإنها تحكم بالكفر على الفرد المعين الذي رضي الكفر وأعلنه، أو التجمع الذي أشهر الكفر ورفع رايته، لكن جماهير المسلمين يبقون تحت عنوان “الأمة الإسلامية” ويحكم عليهم بالإسلام.
لذلك فالدعاة المسلمون والجماعات الإسلامية التي تنطلق من اعتبار أن الواقع يقوم على وجود “أمة إسلامية” لا تتعامل مع هذا الواقع بمصطلحات “دار الحرب و دار الإسلام” أو “مرحلة مكية و مرحلة مدنية”، لأنها ترتبط مع هذه الأمة بعلاقة حميمة تقوم على أن هذه الأمة أمتها، لذلك تحرص على وحدة هذه الأمة وقوتها وعزتها ومنفعتها وثروتها… إلخ، وتتعاون مع كل من يقف إلى جانب أمتها، وتقاتل كل من يعتدي على هذه الأمة، أو يحتل أرضها، أو ينتهك حرمتها، دون أن تنتظر وجود خليفة لأن هذا الاحتلال هو إضعاف للأمة الذي هو إضعاف للإسلام.