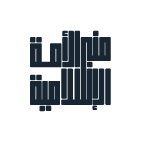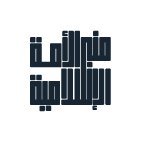معالجات المسألة الثقافية بين قرنين
زاد الاهتمام بالمسألة الثقافية بعد أحداث 11 سبتمبر2001م، وتكرّر الحديث عن ضرورة إحداث تغييرات ثقافية واسعة في منطقتنا العربية في القرن الحادي والعشرين، وطرحت أمريكا من أجل تحقيق تلك الغاية “مبادرة الشراكة الأمريكية-الشرق الأوسطية” في 12/12/2003م على يد كولن باول وزير الخارجية الأمريكية آنذاك، كما طرح جورج بوش رئيس الولايات المتحدة “مشروع الشرق الأوسط الكبير” الذي ناقشته
ووافقت على تبنّيه الدول الصناعية الكبرى الثماني في حزيران (يونيو) من عام 2004م، وقد تضمّن المشروعان السابقان الصادران عن مؤسّسات أمريكية ودولية توجّهات نحو إحداث تغيير في كل تفريعات المسألة الثقافية في منطقتنا من مناهج، وإعلام، ولغات، وطرق تربية، ومدارس، وخطاب ديني إلخ…، واستهدف المشروعان إقامة ورش عمل للتدريب على العمل الديمقراطي، والممارسات الانتخابية والنقابية إلخ…، واعتمد المشروعان تعميم ثقافة حقوق الإنسان، وحرية المرأة، والمبادئ الديمقراطية إلخ…، ورصد المشروعان مبالغ مالية من أجل الإنفاق على مراكز التدريب والتعليم والورش والمؤتمرات والدعاية المرتبطة بهما.
والسؤال الآن: هل الاهتمام بالمسألة الثقافية أمر جديد على المنطقة؟ الجواب: لا، بل هو قديم منذ القرن التاسع عشر، فقد اهتم رفاعة رافع الطهطاوي وهو أول مَعْلَم من معالم النهضة بالمسألة الثقافية، وربما كانت المسألة الثقافية اهتمامه الأول، فقد كتب رسالته المشهورة “المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين” في صدد الحديث عن التعليم والتربية والمدارس، كما أنشأ داراً للترجمة من أجل نقل جانب من التراث الفرنسي الذي اطلع عليه أثناء مرافقته للبعثة المصرية خلال إقامته في فرنسا.
وأكّدت سيرة محمد عبده (ت 1905م) أبرز رموز النهضة أيضاً الاهتمام بالمسألة الثقافية، فقد كتب مذكّرتين في إصلاح التعليم قدّم إحداهما إلى شيخ الإسلام في استنبول، والثانية إلى اللورد كرومر في مصر، وكتب رسالة في إصلاح الأزهر تناولت المدرسين ونظام التدريس والامتحان وكتب التدريس ورواتب المدرّسين إلخ…، وقدّم هذه الرسالة إلى مجلس إدارة الأزهر الذي أصبح عضواً فيه، وكتب مذكّرة في إصلاح المحاكم الشرعية، كما وضع لائحة لإصلاح المساجد وقدّمها إلى مجلس الأوقاف لإقرارها والعمل بها، وأنشأ جمعية إحياء الكتب العربية افتتحها بطباعة كتاب “المخصص” لابن سيده إلخ… وألّف محمد عبده كتباً عالجت مختلف النواحي الثقافية والدينية، فألّف “رسالة التوحيد” التي عالجت الجانب العقائدي في تراث الأمّة، كما ألّف “تفسير المنار” الذي عالج التقريب بين الغيب الديني والمادية الغربية إلخ…
ثم زاد الاهتمام بالمسألة الثقافية بعد الحرب العالمية الأولى إثر التغييرات الكبيرة التي مرّ بها العالم العربي، ويمكن أن نمثّل على ذلك بطه حسين الذي ألّف كتاباً خاصاً عن الثقافة إثر إعلان استقلال مصر عام 1936م، سمّاه “مستقبل الثقافة في مصر” وقد تحدّث في هذا الكتاب عن التعليم، واللغات الأجنبية، وواجبات المعلّم، وواجبات الدولة تجاه المعلّم، والأزهر، واللغة العربية، والعلوم الدينية إلخ…، ثم استلم طه حسين وزارة المعارف في يناير عام 1950م، واستمرّ وزيراً إلى يناير عام 1952م، وكانت فرصة لتطبيق رؤاه الثقافية، وبالفعل من أشهر أفعاله أثناء تولّيه الوزارة، حرصه على تعميم التعليم وتوسيع دائرة المتعلّمين، وإطلاق مقولته المشهورة حيث قال: “التعليم يجب أن يكون بالنسبة للمصري كالماء والهواء”.
خلاصة القول: إنّ الاهتمام بالمسألة الثقافية قديم، وقد ساهم في طرح مشاكلها ووضع الحلول لها كل رموز النهضة، ومع ذلك فإنّ النتائج كانت مخيّبة للآمال على مستوى العالم العربي: أُمّية متفشّية بلغت (70) مليوناً في العالم العربي، عدد الاختراعات والابتكارات محدود، المراكز البحثية محدودة، الكتب المترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية قليلة بالمقارنة مع ترجمات دولة كاليونان، الكتب المؤلّفة قليلة بالمقارنة بالكتب المؤلّفة في دولة مثل اسرائيل إلخ…
لماذا جاءت النتائج بهذه الصورة مع الاهتمام الواسع المستمرّ بالمسألة الثقافية خلال القرن الماضي؟ لا يكمن النقص والخطأ في الاهتمام بالمسألة الثقافية ومعالجته، ولكن يكمن الخطأ في رؤية الواقع البشري والاجتماعي والنفسي والعقلي المرتبط بالمسألة الثقافية، والإجابة الخاطئة على أسئلة من مثل: من هو الإنسان الذي نتّجه إليه لمعالجة مشكلته الثقافية؟ ومن هو المجتمع الذي نخاطبه؟ وسنأخذ مثالاً على ذلك طه حسين وكتابه الذي استشهدنا به من قبل وهو “مستقبل الثقافة في مصر”.
تحدّث طه حسين في بداية كتابه عن العقل المصري وقرّر أنه متّصل بالعقل الأوروبي، وأنه ليس هناك فرق جوهري بينهما، وأنّ الشعب المصري متأثّر بشعوب البحر الأبيض المتوسّط، واعتبر طه حسين أنّ الإسلام لم يخرج مصر عن عقليتها الأولى، وبأنّ رضا مصر عن الفتح الإسلامي لم يبرأ من السخط، ولم يخلص من الثورة والمقاومة، وبأنها لم تهدأ ولم تطمئن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة في ظلّ ابن طوسون، وفي ظلّ الدول المختلفة التي قامت بعده.
ويتصل هذا الكلام الذي ذكره طه حسين في كتاب “مستقبل الثقافة في مصر” اتصالاً وثيقاً بوجهات نظره الأخرى التي عبّر عنها في منابر أخرى سياسية وأدبية وثقافية، إذ دعا فيها إلى القومية المصرية الفرعونية، والتي اعتبر فيها أنّ الشعب المصري يشكّل “أمّة مصرية” مستقلّة، كما اعتبر أنّ مصر هي “الوطن المصري”.
لا أريد أن أناقش وجهات النظر السابقة ومدى خطئها وعدم صوابيتها، فقد فعلت ذلك في مكان آخر كما فعل ذلك غيري، ولكني أشير إلى أنّ هذا هو أحد الأسباب الرئيسية الذي جعل الخطط الثقافية لا تنجح ولا تعطي ثمارها، إذ كيف تنجح ونحن لم نعرف ذاتنا معرفة صحيحة؟ فكيف يكون الشعب المصري “أمّة مصرية” بالمعنى الفرنسي للأمّة التي تعتمد العوامل الجغرافية في تكوين الأمّة وليس جزءاً من أمّة عربية إسلامية؟!! وكيف تكون مصر “وطناً” بالمعنى الأوروبي لكلمة “الوطن” وليس جزءاً من الوطن العربي الإسلامي؟ وكيف لم يخرج الإسلام “العقل المصري” عمّا كان عليه قبل الإسلام ونتجاهل كل الآثار الثقافية والعلمية والتربوية والفنية التي تركها الإسلام في واقع الحياة المصرية؟
هذه هي العوامل التي جعلت معالجات المسألة الثقافية في القرن العشرين لا تعطي ثمارها ونتائجها الصحيحة، فهل المعالجات في القرن الحادي والعشرين ستتجنّب تلك الأخطاء؟ الملاحظ أنّ معالجات المسألة الثقافية في القرن الحادي والعشرين، تقع في الخطأ ذاته التي وقعت فيها معالجات القرن العشرين، بل ربما في خطأ أسوأ، فهي تنظر إلى المنطقة على أنها جغرافيا ممتدّة فارغة تريد أن تملأها بالمضمون الثقافي الذي تريده، وهي توسّعها مرّة كما في “مشروع الشرق الأوسط الكبير”، فتجعلها ممتدّة من باكستان إلى المغرب مروراً بأفغانستان وإيران وتركيا واسرائيل، وهي تضيّقها مرّة أخرى لتجعلها ممتدّة من إيران إلى المغرب كما في التعديلات الأوربية له.
إنّ تلك الرؤية للواقع البشري تشير إلى أننا لم نستفد من كل التجارب السابقة في القرن العشرين، وإلى أننا ربما سننتهي إلى نتائج أسوأ في معالاجات المسألة الثقافية في القرن الحادي والعشرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(1) نشر هذا المقال في جريدة “الحياة” بتاريخ 10/3/2005م في صفحة (أفكار).
السبت في 28 من صفر 1426ﻫ
الموافق 6 من نيسان (ابريل) 2005م
المشرف
الشيخ الدكتور غازي التوبة