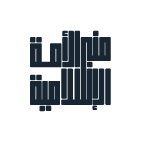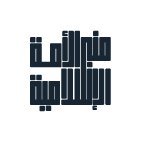حياتنا الفكرية بين النقل الحرفي والنقد الغائب
ما زالت الأمة تحاول النهضة والعودة إلى سدة الريادة على مستوى الأمم منذ سقوط الخلافة عام 1926، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل لعدة أسباب أبرزها الفقر الثقافي في واقعنا المعاصر، وهذا الفقر الثقافي يعود إلى سببين رئيسيين، الأول: النقل الحرفي عن الحضارة الغربية، الثاني: قلة النقد الفكري إن لم نقل غيابه بالكلية.
وكنت قد نشرت مقالا يوضح هذا القصور في (الجزيرة نت) في قسم (المعرفة) في زاوية (وجهات نظر) بالتفصيل، استشهدت فيه بأدلة من التيارات القومية والليبرالية والشيوعية والإسلامية.
حياتنا الفكرية بين النقل الحرفي والنقد الغائب
تتّسم حياتنا الفكرية بشكل عام -ما عدا بعض الاستثناءات- بالنقل الحرفي عن الحضارة الغربية، ومحدودية النقد إن لم يكن غيابه فيما يتعلّق بواقعنا الفكري، وولّد هذا الوضع فقراً ثقافياً وعدم إبداع، ويمكن أن نمثّل على ذلك بأدلّة من التيارات القومية والليبرالية والشيوعية والإسلامية.
بدأ الفكر القومي العربي نشاطه في القرن التاسع عشر، وأشعل الثورة العربية الكبرى في عام 1916، وكان الأصل في قيام عدّة دول بعد الحرب العاليمة الأولى، وهو اعتبر الأمّة العربية تقوم على عنصري: اللغة والتاريخ، وهو في هذا ينقل ما قرّرته المدرسة الألمانية في بناء الأمّة وتكوّنها، لذلك تنكّر للدين كما تنكّرت القومية الأوروبية للدين، وهو لم يقم بدراسة الواقع العربي الذي يؤكّد أنّ الدين الإسلامي عنصر أساسي في بناء هذه الأمّة وتكوينها، ويدخل بشكل واضح في بناء العادات والتقاليد والثقافة، والآمال والتطلّعات، ويدخل في بناء النفس والعقل والتفكير والوجدان… إلخ.
إنّ النقل الحرفي للفكر القومي الأوروبي بشكل عام والألماني بشكل خاص، وإسقاطه على واقع أمّتنا دون أدنى محاولة لتمحيص هذا المفهوم، ورؤية المباينات بين الواقعين العربي والألماني أثّر تأثيراً كبيراً على تأخير قيام نهضتنا، عدا أنه قام بدور تخريبي في بناء الأمّة الثقافي والاجتماعي والاقتصادي… إلخ.
تواجد التيار الليبرالي في عالمنا العربي منذ القرن التاسع عشر، ودعا إليه بعض الكتّاب والمفكّرين، ثم حكم التيار الليبرالي عدداً من الدول العربية بعد الحرب العالمية الأولى بدءاً من العراق، ومروراً بمصر وسوريا ولبنان والأردن، وانتهاء بتونس. وقد قامت في هذه الدول نُظُم ديمقراطية، وضعت الدساتير التي تنص على فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأُجريت الانتخابات، وقامت الأحزاب، وصدرت الصُحُف، وأُقرّت الحريات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية… إلخ، وكان كل هذا تقليداً لتجارب أوروبا الليبرالية ونسخاً عنها، وبلغت ذروة النقل للتجربة الليبرالية في دعوة طه حسين إلى أخذ الحضارة الغربية: حلوها ومرّها دون أدنى تمييز، واعتباره أنّ هذا هو طريق النهضة والتقدّم والنور والخير، وحاول أن يجد لذلك مبرّرات من مثل اعتباره أنّ العقل المصري عقل أوروبي، وأنّ مصر جزء من الغرب باستمرار.
يجد المتابع لتجربة التيار الليبرالي في منطقتنا، أنها تجربة نقل حرفي لما كانت عليه الليبرالية في أوروبا والغرب، ولم ينظر التيار الليبرالي إلى ظروف المنطقة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية… إلخ، كما لم يراع ظروف أبنائها: النفسية والثقافية والعقلية… إلخ، كما لم ينظر إلى بعض المشاكل والأزمات التي تعاني منها، إنّ هذا النقل الحرفي لليبرالية كان أحد العوامل في عدم تجذّرها في المنطقة، وانزياحها –بعد ذلك- بسهولة عن ساحة الأحداث بعد الحرب العالمية الثانية.
تشكّلت الأحزاب الشيوعية في معظم البلدان العربية بعد قيام الثورة الشيوعية في روسيا عام عام 1917، ودعت إلى تطبيق الماركسية والشيوعية، ثم أقامت مصر علاقة مع الاتحاد السوفياتي عام 1955، واشترت سلاحاً منه، ثم طبّقت مصر القوانين الاشتراكية في الستينيات، وانتقلت هذه الصورة من التطبيقات الاشتراكية إلى عدد من الدول العربية وهي: سوريا، والعراق، والجزائر، وليبيا، والسودان، وعدن، والصومال، واليمن… إلخ.
والجدير بالملاحظة أنّ كل الدعوات الاشتراكية التي قامت في العالم العربي نقلت أقوال الاشتراكية العلمية وتطبيقاتها بشكل حرفي دون أدنى مراعاة لظروف المنطقة وتطوّراتها التاريخية ومشكلاتها، لذلك ارتفعت وتيرة المجاهرة بمعاداة الدين والدعوة إلى المادية والاستهزاء بالغيب، واعتباره أساس التخّلف كما هو واقع بالغرب في العصور الوسطى، كما ارتفعت وتيرة الدعوة إلى العنف الثوري، وإلى استئصال الطبقة البرجوازية والإقطاعية، لأنهما أصل الرجعية والتخلّف والعمالة للأجنبي، كما سادت الدعوة إلى تأميم كل الشركات، وإلغاء القطاع الخاص وتحويله إلى قطاع عام، لا شك أنّ هذه الدعوات والتطبيقات تركت أسوأ الأثر في بناء الأمّة، فازدادت مساحة الفقر، وتدهور الاقتصاد، وتخلّف الإنتاج.
وقد نتج كل ذلك بسبب النقل الحرفي لمقولات الاشتراكية العلمية دون أدنى إبداع في النظر إلى الواقع المطبّق، مع أنّ النظر إلى الواقع يدعونا إلى القول بأنّ الدين الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام أفيوناً للشعب كما طرحت الاشتراكية العلمية، بل كان الدين عنصراً من عناصر التعبئة الثورية في أكثر من مكان في العالم الإسلامي، وقد كان الأصل في تثوير الجماهير ضدّ الاستعمار، وكان المحرك الأساسي في استقلالها.
ولم تكن لدينا طبقة بورجوازية وإقطاعية بالمعنى الذي طرحته الاشتراكية العلمية، لذلك لم يكن هناك داعٍ للدعوة إلى العنف الثوري والصراع الطبقي، وكان يمكن تحقيق العدالة الاقتصادية بدماء أقل. ولم تكن لدينا شركات رأسمالية بالمعنى الذي طرحته الاشتراكية العلمية، وحتى ماركس اعتبر أنّ هناك نموذجاً آخر في المنطقة الآسيوية هو النموذج الآسيوي للإنتاج لم تعرفه أوروبا، ومع ذلك لم يسع الاشتراكيين في العالم العربي ما وسع ماركس، بل أصرّوا على تطبيق مقولات الاشتراكية العلمية بصورة حرفية مما أدّى إلى خلخلة في البناء الثقافي، وفوضى في الأخلاق، واضطراب في القِيَم، وتأخّر في الاقتصاد… إلخ.
تشكّل تيار إسلامي بعد الحرب العالمية الأولى ذو ملامح خاصة مرتبطة بالظروف المحيطة به من مثل سقوط الخلافة العثمانية، وتجزئة البلاد العربية، وقيام السيطرة الاستعمارية، ووجود الغزو الفكري من قِبَل الحضارة الغربية لثقافة أمّتنا… إلخ، وقد احتوى هذا التيّار عدّة حركات في أقطار مختلفة: فكان الإخوان المسلمون بقيادة حسن البنّا في مصر، وكان حزب التحرير بقيادة تقي الدين النبهاني في فلسطين، وكانت جماعة النور التابعة لمحمد سعيد النورسي في تركيا، وكانت الجماعة الإسلامية بقيادة أبي الأعلى المودودي في باكستان، وهناك جماعات أخرى في الهند وإندونيسيا والجزائر… إلخ.
لم تستطع أيّة حركة من الحركات الإسلامية أن تنجح في تحقيق الأهداف التي كانت تنشدها الأمّة من قيامها، وهي: ترسيخ مشروع حضاري إسلامي من خلال دولة إسلامية فاعلة ذات قيادة سياسية رائدة.
وأعتقد أنّ هناك عدّة أسباب وراء هذا الفشل، لكنّ أبرزها هو محدودية النقد لأعمالها وللواقع المحيط بها، إن لم يكن غياب هذا النقد في بعض الأحيان، ووجود هذا النقد يشير إلى الفاعلية العقلية التي هي من أهم العناصر التي نحتاجها في بناء أوضاعنا الحالية، وغيابه يدل على غياب الفاعلية العقلية التي تعني الجمود والركود والتأخّر والفقر الثقافي… إلخ، وأحبّ أن أنبّه منذ البداية على أمرين:
الأول: إنّ النقد الذي أتحدّث عنه لا يعني المدح أو القدح في المنقود، لكنه يعني النظر العلمي الموضوعي إلى ما هو منقود، وتقويمه وتوضيح ما فيه من إيجابيات وسلبيات، وإلى تحليله والتمييز بين العناصر الجديدة المضافة والعناصر القديمة المنقولة عن غيره، وإلى مدى قيمة هذا المنقود وفائدته للأمّة والأفراد، وإلى فرز ما هو منقود وترتيبه حسب الأهمية، وإلى الترجيح بينه وبين مشابهاته… إلخ.
الثاني: إنّ النقد منهج قرآني أصيل، فقد انتقد القرآن الكريم تصرّفات الصحابة رضي الله عنهم في بعض الغزوات ووجّههم إلى ما هو أصوب، فانتقد في غزوة بدر اختلافهم على الأنفال، وردّها إلى الله والرسول فقال تعالى: “”يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ”” (الأنفال/1)، ثم انتقد رغبتهم في غير ذات الشوكة، لكنّ الله أمضى إرادته ومشيئته فكانت غزوة بدر فقال تعالى: “”وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ”” (الأنفال/7)، وإذا تتبعنا بقية الأحداث والغزوات التي حدثت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كغزوات أُحُد والأحزاب وحُنَيْن وبني المصطلق وجيش العُسْرَة وفتح مكّة… إلخ، فسنجد مئات الآيات التي توجّه الصحابة، وتقوّم تصرّفاتهم وتعلّمهم، وتأمرهم وتنهاهم، وتُخْفض بعض الأخلاق وترفع بعضها الآخر.
وما حفل القرآن الكريم بهذا النقد والتقويم والتوجيه الحفول الكبير إلا ليُرسّخ هذه القيمة في حياة المسلمين، ويعلّمهم أهمية النقد والمراجعة والتمحيص والتقويم في حياتهم المستقبلية، وأنه يجب أن يكون مرادفاً لوجودهم.
وقد استوعب المسلمون هذا الدرس في العصور السابقة، فانتقد الشافعي مالكاً، وهو أستاذه، ودَوَّنَ “”اختلاف مالك”” في كتاب “”الأُمّ””، وانتقد موقفه من حديث الآحاد، كما انتقد الأشعري الذين عاصروه والذين سبقوه، وقس على ذلك الجُوَيْني والغزالي وابن تيمية والعزّ بن عبد السلام، والشاطبي… إلخ، فستجد كتبهم مملوءة بنقد ما هو سابق سواء أكانوا أشخاصاً أم كانوا مناهج وأفكاراً.
لكنّ المسلمين للأسف نسوا هذا الدرس خلال مائة السنة الماضية، فنجد أنّ هناك حركات متعدّدة تشكّلت، وتجارب قامت، وأفكاراً كثيرة طُرحت، وعلماء كثيرين نهضوا وتحدّثوا وكتبوا، ولكن بالمقابل نجد نقداً محدوداً لهذه الحركات والتجارب والأفكار والعلماء، فلو أردت أن تحصي الكتب التي تحدّثت عن الحركات الإسلامية، وعن إيجابيّاتها وسلبيّاتها من مثل حركات الإخوان المسلمين، وحزب التحرير، والجماعة الإسلامية في باكستان، وجماعة النور في تركيا… إلخ، فستجد بعض الكتب المحدودة، هذا إذا وجدت بُغيتك، وستجد بعضها لا قيمة له ولا فائدة منه.
وإذا أردت أن تحصي الكتب التي قوّمت ونقدت أعمال العلماء والكتّاب والمفكّرين المعاصرين من أمثال محمد البهي والبهي الخولي وعبد القادر عودة ومحمد الغزالي وسعيد حوّى ومصطفى السباعي ومحمد رشيد رضا ومحمد عبد الله دراز ومحمد عزة دروزة وعلاّل الفاسي ومحمد فريد وجدي… إلخ، ستجد حيناً نقداً محدوداً، وحيناً آخر نقداً لا غناء فيه، وحيناً ثالثاً لا تجد أيّ نقد.
وإذا أردت أن تحصي الدراسات التي نقدت وقوّمت التجارب المعاصرة التي كان التيار الإسلامي وقوداً لها من مثل الثورة في سوريا عام 1981، وتجربة الحكم الإسلامي للسودان عام 1989 وأسباب تعثّرها، وتجربة الثورة الإسلامية في الفلبين بقيادة جبهة تحرير مورو… إلخ فلن تجد شيئاً ذا قيمة.
ويمكن أن أنتقل من التعميم إلى التخصيص من خلال مثالين:
الأول: الفكر القومي العربي وساطع الحصري: حكم الفكر القومي العربي المنطقة خلال مائة السنة الماضية، وكان له أثر كبير في توجيه المنطقة وصياغتها والتأثير فيها، ويعتبر ساطع الحصري من أبرز أعلامه إن لم يكن أبرزهم وأغزرهم إنتاجاً، وأعمقهم على الإطلاق، فلو تساءلنا: أين الكتابات الإسلامية التي تناولت الفكر القومي العربي وساطع الحصري بمنظار إسلامي وبرؤية إسلامية؟ لا تجد شيئاً. لكنك ستجد بعض الدراسات التي تناولت ساطع الحصري بعيون ماركسية، كما فعل إلياس مرقص في نقده لساطع الحصري في كتاب “”نقد الفكر القومي””، وستجد بعض الدراسات التي تناولت ساطع الحصري من منظار قومي أيضاً.
الثاني: تجربة الجهاد الأفغاني التي وقعت بين عامي 1979-1992: ساهمت معظم الحركات الإسلامية، والعلماء المسلمين، وجمهور المسلمين في الجهاد الأفغاني، وقدّمت الأمّة الإسلامية الدماء والأموال والجهود في سبيل دحض الشيوعية، وكانت تجربة غنية، فلو تساءلنا: أين الدراسات التي رصدت تلك التجربة بكل تفاصيلها: المالية، والإدارية، والقتالية؟ وأين التقويم لهذه التجربة؟ وما نتائجها على الأمّة؟ وأين النجاح وأين كان الفشل؟ أين الكتابات التي رصدت كل ذلك؟ لا تجد أي كتابات ذات قيمة بمنظار إسلامي، وإنما تجد بعض الكتابات المحدودة التي تتناول أجزاء متفرّقة من هذه التجربة. مع أنه يفترض أن نجد عشرات المؤلّفات التي تتناول التجربة بكل تفصيلاتها لأنها كانت منعطفاً في حياة الأمّة، وفي آثارها عليها.
الخلاصة
إنّ الركود الذي تعانيه الأمّة، وإنّ النهضة التي لم تتحقّق، لم يأتيا من فراغ إنما جاءا نتيجة غلبة النقل الحرفي لمعطيات الحضارة الغربية إلى واقعنا دون اجتهاد في مراعاة الواقع الموضوعي للأمّة عند الأخذ بهذه المعطيات، وإلى محدودية النقد والتقويم عند التيار الإسلامي لعشرات التجارب والحركات المعاصرة، ولمئات الكتّاب والعلماء المعاصرين إن لم نقل غياب هذا النقد والتقويم.