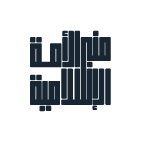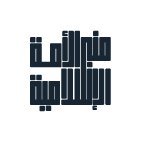الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بين مؤيديه ومعارضيه
ظهر لون جديد من تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث يربط بين الآيات القرآنية وبين الحقائق العلمية المكتشفة، وكان من أبرز أعلامه في القرن الماضي محمد فريد وجدي وعبد الرزاق نوفل إلخ… وتضاربت مواقف الدارسين في شأنه، فبعضهم رفضه بحجة أن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب جغرافيا وجيولوجيا وعلوم إلخ… وبحجة خطورة ربط حقائق القرآن الكريم الثابتة المطلقة بالنظريات العلمية المتغيرة النسبية، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطراب ثقة الناس بالقرآن الكريم، وبحجة عدم انطباق تعريف المعجزة على هذا التفسير المسمى بالإعجاز العلمي، فما قيمة مثل هذا المنهج في التفسير؟ وما وزن الحجج الرافضة له؟
إن نظرة سريعة إلى القرآن الكريم تؤكد لنا كثرة الآيات الكريمة التي أشارت إلى مظاهر الكون وإلى بعض النواميس والقوانين والنظريات التي تحكم حركة الكون، والتي قدرها بعض الباحثين بسدس آيات القرآن الكريم، وليس من شك بأن هناك حكمة من وجود مثل هذه الكثرة من الآيات، وأبرز عناصر هذه الحكمة: توليد تعظيم الله، وتوليد الثقة به تعالى، وتوليد رجائه تعالى إلخ… ويمكن أن نمثل على ذلك بقوله تعالى: (ألم نجعل الأرض مهاداً . والجبال أوتاداً . وخلقناكم أزواجاً . وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً . وبنينا فوقكم سبعاً شداداً . وجعلنا سراجاً وهاجاً . وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً . لنخرج به حباً ونباتاً . وجنّات ألفافاً) (النبأ،6-16)
فقد لفتت الآيات الأنظار إلى الأرض الممهدة، وإلى الجبال المنتصبة، وإلى مبدأ الزوجية في الخلق، وإلى جعل النوم راحة للإنسان، وإلى ظاهرتي الليل والنهار، وإلى السماوات المبنية، وإلى الشمس الملتهبة، وإلى نزول المطر ودوره في نماء النبات، إن تلك الظواهر: الأرض والجبال والنوم والليل والنهار والشمس والماء والنبات التي أشارت إليها الآيات تبني تعظيم الله في القلب، وتبني الثقة به تعالى وتبني رجاءه تعالى، وتوجه إلى حمده وشكره تعالى على تلك النعم، توجّهه إلى كل ذلك ولو كانت النظرة في أبسط حالاتها وهي النظرة الخارجية السطحية.
لكنّ تعظيم الله يزداد، والثقة به تعالى تزداد، ويزداد التعظيم كذلك للقرآن الكريم والثقة به عندما تتطابق الحقائق العلمية مع الإشارات القرآنية، ونستطيع أن نمثل على ذلك بحديث القرآن الكريم عن الجبال: فقد تأكد في علم الجيولوجيا أن هناك كتلاً يابسة منغرسة في الأرض أضعاف ما هو ظاهر من الجبل، وتقوم هذه الكتل المنغرسة بحفظ توازن الأرض، ولولاها لاضطربت الأرض واختل توازنها، عند ذلك نجد لقوله تعالى: (والجبال أوتاداً) أبعاداً أخرى، وأبرزها أن التشابه بين صورة الجبال المنغرسة في الأرض، وصورة الأوتاد المرتبطة بالخيمة ليس تشابهاً ظاهرياً فقط، بل هو تشابه على الحقيقة، فكما أن الوتد يثبت الخيمة كذلك فالجبل يثبت الأرض، وعندما يطلع المسلم على مثل هذا التفسير يزداد تعظيمه لله تعالى وللقرآن الكريم.
وإذا أخذنا قوله تعالى: (وبنينا فوقكم سبعاً شداداً) فعندما ينظر المسلم إلى السماء فوقه نظرة بسيطة سريعة، فإن هذه النظرة تجعله يشعر بالقوة والشدة والإحكام في بناء السماء ويتولّد عنده تعظيم الله تعالى والثقة به تعالى ورجاءه تعالى نتيجة هذه النظرة البسيطة السريعة، لكنه عندما يعلم أن العلم الحديث اكتشف أن هناك سبع سماوات وتطابق ذلك مع قول القرآن الكريم، ثم عندما يأتي العلم الحديث بتفصيلات عن ضخامة بناء السماوات، وسعتها، وإحكامها إلخ… من مثل أن هناك مائة ألف مليون نجم في كل سماء، وأن هذه النجوم تدور في أفلاك منتظمة منذ ملايين السنين لا تتصادم، ولا تتوقف، لاشك أن مثل هذا يجعل المسلم يزداد تعظيماً وثقة ورجاء وحمداً لله تعالى، كما يجعله يزداد تعظيماً وثقة وحبّاً للقرآن الكريم، وهذا نفي لحجة المعترضين الأولى، فقد بقي القرآن الكريم كتاب هداية، بل ازدادت الهداية وتعمّقت – كما رأينا – مع الربط بين الآيات الكريمة والحقائق العلمية.
أما بالنسبة للحجة الثانية التي تدعي بأن الربط بين الآيات الكريمة وبين الحقائق العلمية قد يهز الثقة في القرآن الكريم وبخاصة عندما يتغير الموقف العلمي، فإن هذه الحجة ضعيفة لأن الربط يجب أن يكون بين الحقائق العلمية وبين صريح القرآن الكريم، والحقائق العلمية لا تتغير، وعندما تتغير فهي ظنون علمية وليست حقائق علمية، وكما قال علماؤنا السالفون وأبرزهم ابن تيمية عندما نفى أن يكون هناك تعارض بين صحيح المعقول وصريح المنقول وألف في ذلك كتاباً من أعظم الكتب في التاريخ الإسلامي وسماه: “درء تعارض النقل والعقل” أو “موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول”.
وقد قرّر ابن تيمية في الكتاب السابق أنه لابد من توافق الصحيح من كل علوم العقل مع الصريح من كل أقوال النقل، وإذا حدث تعارض فهذا يعني أحد أمرين: إما أن العلم العقلي غير صحيح فهو ليس علماً، وإما أن القول المنقول ليس ثابتاً فهو ليس من الإسلام.
أما بالنسبة للحجة الثالثة فهي ترفض الإعجاز العلمي بحجة أنه لا ينطبق عليه تعريف المعجزة التي عرّفها علماء الأصول، وقد سمعت هذه الحجة في برنامج “الشريعة والحياة” الذي استضاف الدكتور زغلول النجار، والذي يعتبر من أبرز الرموز الداعية إلى هذا النهج في التفسير، وما سمعته في هذا البرنامج هو الذي دعاني إلى كتابه هذا المقال، والصحيح أن هذه الحجة واهية أيضاً، لأن مصطلح المعجزة مصطلح جديد لم يرد في قرآن ولا سنة، وقد استخدم القرآن الكريم لفظ الآيات للدلالة على المعجزات فقال تعالى:
(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ) (الإسراء،101).
وقال تعالى: (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالآياتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً) (الإسراء،59)،
وكذلك استخدمت السنة اللفظ نفسه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : “ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّ، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة”. (رواه مسلم).
وقد عرّف العلماء المعجزة فقالوا: “المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة من المرسل إليهم”، فالمعجزة حسب التعريف السابق لها ثلاثة أركان: الأول: حدوث أمر خارق للعادة، الثاني: تحدي الناس المعاصرين بهذا الأمر الخارق، الثالث: عجز الناس المعاصرين عن المعارضة.
لو طبقنا مصطلح المعجزة على معجزات الأنبياء لوجدنا كثيراً من المعجزات لا تندرج تحت ذلك المصطلح بأركانه الثلاثة، ولو أخذنا موسى عليه السلام كمثال على ذلك فنجد أن هذا المصطلح بأركانه الثلاثة ينطبق فقط على معجزتين من المعجزات التسعة التي أعطاه الله تعالى إياها وهما العصا واليد، فهما اللتان تحدى بهما موسى عليه السلام فرعون وهما اللتان عجز الناس عن معارضتهما، قال تعالى:
(وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى . قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى . قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى . فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى . قَالَ خُذْهَا وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولَى . وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى . لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى . اذهب إلى فرعون إنه طغى) (طـه،17-24).
أما المعجزات السبع المكملة للمعجزتين السابقتين التي أجراها الله تعالى على يدي موسى عليه السلام، والتي أشارت إليه آية الإسراء، فهي: الدم، والضفادع، والقمّل، والجراد، والجدب، ونقص الثمرات، والطوفان، فلم يقصد بها التحدّي، قال تعالى: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ) (الأعراف،133).
هذا مع العلم بأن الله أجرى على يدي موسى عليه السلام معجزات أخرى كثيرة لا تدخل ضمن المعجزات التسعة الموجهة إلى فرعون وقومه، ومنها: معجزة شق البحر لإهلاك فرعون وجنوده، ومعجزة ضرب العصا في الأرض لتفجير اثنتي عشرة عيناً من أجل أن تشرب أسباط بني اسرائيل، ومعجزة إهلاك عدد من رجال بني اسرائيل ثم إحيائهم، ومعجزة رفع الطور فوق بني اسرائيل وهو الجبل العظيم ودعوتهم إلى أخذ الميثاق بقوة، وقد وردت آيات متعددة عن كل تلك الوقائع في القرآن الكريم، فتحدث القرآن عن معجزة شق البحر لإنجاء بني اسرائيل، قال تعالى: (فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ . وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ . ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ) (الشعراء،63-66).
وتحدث القرآن الكريم عن معجزة انفجار العيون من الحجر فقال تعالى: (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ) (البقرة،60).
وتحدث القرآن الكريم عن إهلاك بعض رجال بني اسرائيل عندما طلبوا رؤية الله جهرة ثم إحيائهم فقال تعالى: (وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ . ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
(البقرة،55-56).
وتحدث القرآن الكريم عن معجزة رفع الطور فوق بني اسرائيل فقال تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة،63).
ومن الواضح أن الله تعالى أجرى هذه المعجزات على يدي موسى لحكم متعددة منها: زيادة يقين بني اسرائيل بنبوة موسى عليه السلام ، وحضهم على تنفيذ تعليمات التوراة، وإجزال النعم عليهم من أجل تعميق إيمانهم بالله تعالى إلخ…
ولو طبقنا مصطلح المعجزة على ما أجراه الله تعالى على يدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من معجزات لوجدناه ينطبق على معجزة واحدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وهي معجزة القرآن الكريم حيث قال تعالى:
(وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ[ (البقرة،23-24).
أما معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الأخرى الكثيرة من مثل الإسراء والمعراج، وانشقاق القمر، ونبع الماء من بين يديه، وتكثيره الطعام القليل، وتكليمه الشجر والحجز إلخ… فلا ينطبق عليها مصطلح المعجزة السابق لأنها لم يقصد بها تحدي المدعوّين، وإنما كانت لحكم متعددة أبرزها التسرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبيت المؤمنين، وزيادة إيمانهم بدعوة الإسلام، وزيادة يقينهم بنبوة
محمد صلى الله عليه وسلم إلخ…
نخلص من كل الكلام السابق أن هذا التفسير العلمي للآيات القرآنية فيه خير كثير، فهو يزيد الهداية، ويعمق اليقين بإلهية القرآن الكريم، وقد جاء الإشكال والالتباس عند كثير من المسلمين من إسقاط مفاهيم مصطلح المعجزة على هذا التفسير، فإذا عرفنا أن مصطلح المعجزة جديد، وأن مضمونه حدّده بعض علماء أصول الدين، وأن المصطلح الذي استخدمه القرآن والسنة للدلالة على المعجزة والمعجزات هو مصطلح “الآية والآيات”، وأن كثيراً من المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد الأنبياء والرسل ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تدخل ضمن نطاق مصطلح المعجزة الذي قننه بعض العلماء المتأخرين، نكون بهذا التوضيح قد أزلنا كثيراً من الشكوك التي تحوم حول هذا التفسير.