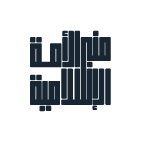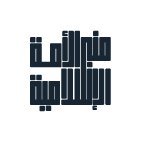القطرية وأخطارها على الأمة الاسلامية
لم تكن هناك أمة مكونة في الجزيرة العربية عندما نـزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء بل كانت هناك قبائل متناحرة، ولهجات مختلفة، وأديان متعددة، وآمال متصادمة، وكيانات سياسية على أطراف الجزيرة العربية مستغلَّة من قبل الدول الكبرى في المنطقة وهما:
كيانا الغساسنة والمناذرة في الشام والحيرة اللذان كانا مرتبطتين بدولتي الروم والفرس.
وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ترك على مستوى الجزيرة العربية كلها أمة موحدة تدين بكتاب واحد، وتتجه إلى قبلة واحدة، وتعظم ربّاً واحداً، وتتبع شريعة واحدة، وتقودها قيادة سياسية واحدة إلخ. . .
ثم توسعت الأرض التي تعيش عليها هذه الأمة لتشمل بلاداً مجاورة كبلاد الشام وفارس في آسيا، ومصر في أفريقيا إلخ. . . كما صهرت هذه الأمة في بوتقتها شعوباً أخرى مثل شعوب الفرس والترك والروم والبربر والكرد إلخ. . .
ثم استوعبت هذه الأمة الحضارات والعلوم والثقافات التي كانت موجودة في الأراضي التي توسعت فيها وشكلتّ منها حضارة واحدة ذات شخصية مستقلة وهي إحدى حضارات التاريخ البشري البارزة.
واستمرت هذا الأمة موجودة فاعلة على مدار القرون السابقة، وقد تعرضت في مسيرتها إلى عدة أخطار خارجية وداخلية، وأبرز الأخطار الخارجية الني تعرضت لها الأمة:
الحروب الصليبية وحرب المغول.
فقد استمرت الحروب الصليبية قرنين من الزمان، وساهمت فيها كل دول أوروبا وشعوبها من خلال سبع حملات، واحتل المقاتلون أراضي واسعة في قلب العالم الإسلامي، لكن الأمة الإسلامية استطاعت في النهاية التغلب عليهم وإخراجهم من الأراضي الإسلامية.
كما استطاعت إيقاف الغزو المغولي بعد أن انتصرت عليه في معركة عين جالوت، وكان المد المغولي قبلها قد اكتسح جميع بلدان آسيا ودمر بغداد عاصمة الخلافة العباسية عام 656هـ.
وبالإضافة إلى تلك الأخطار العسكرية الخارجية التي هددت الأمة برزت أخطار داخلية هددت عناصر بناء الأمة وعوامل وحدتها الداخلية، ومن ذلك تشكيك فرقة الزنادقة في القرآن الكريم، وإظهار تناقض آياته.
مما اقتضى عالماً مثل أحمد بن حنبل إلى تأليف كتاب في الرد عليهم حمل عنوان “رسالة في الرد على الزنادقة والجهمية”، واقتضى تشكيل ديوان الزنادقة في خلافة المهدي العباسي من أجل المتابعة القضائية لهم مما يشير إلى استفحال خطرهم.
ومن الأخطار الداخلية الأخرى التي هددت وحدة الأمة “الشعوبية”، والتي قامت على استصغار الجنس العربي والاستخفاف به، والتهوين من شأن اللغة العربية والبيان العربي.
مما دفع كاتباً مثل الجاحظ إلى تأليف أكثر من كتاب في الرد على هذه الشبه وتفنيدها ومنها كتاب “البيان والتبيين” الذي أوضح فيه أصول البيان العربي بالمقارنة مع بيان الأمم الأخرى، واعتدال الأسس التي يقوم عليها هذا البيان العربي وجمالها.
ومن الأخطار الداخلية أيضاً التشكيك في السنة، والذي قامت به فرق مختلفة ومنها المعتزلة، مما جعل الشافعي يخصص جزءاً من كتابه “الرسالة” لتفنيد رأي الذين يقولون بكفاية القرآن الكريم والاستغناء عن السنة والرد عليهم بقولة:
إن القرآن الكريم الذي أوجب طاعة الله وجّه إلى طاعة الرسول وأسس -بالتالي- إلى وجود السنة وقيام شرعيتها.
ومن الأخطار الداخلية أيضاً الفرقة السياسية التي تجلت بقيام عدة كيانات سياسية حتى في عهود القوة الإسلامية أثناء الخلاقة العباسية، من مثل: دولة البويهيين، والسلجوقيين، والحمدانيين، والإخشيديين، والطولونيين، والمرابطين، والموحدين، والطاهريين إلخ. . .
لكن الأمة استطاعت التغلّب على كل تلك المصاعب والأخطار والهزات والتشكيكات بالوحدة الثقافية التي عزّزت بناءها الداخلي ونسيجها الاجتماعي، والتي قامت على دعامتين:
الأولى: القرآن والسنة والعلوم التي ارتبطت بهما ونتجت عنهما.
الثانية: العلماء والفقهاء الذين أفرزتهم الحياة الإسلامية وأعطتهم دوراً قيادياً في المجتمع الإسلامي.
أما الدعامة الأولى للوحدة الثقافية فجاءت من معاني القرآن والسنة وحقائقهما وقيمهما ومبادئهما التي تدعو إلى التوحيد والتطهّر وتزكية النفس ومكارم الأخلاق وإعمار الدنيا والخوف من مقام الله ونبذ الشرك وإقامة شرع الله واتباع الأنبياء إلخ. . . وقد تطلبت سور القرآن الكريم والأحاديث الشريفة علوماً لحفظهما ولفهمها وللبناء عليهما، فمن العلوم التي ارتبطت بالقرآن الكريم أسباب النـزول، والمكي والمدني، والناسخ والمنسوخ، وصور الإعجاز، ومدارس التفسير إلخ. . . ومن العلوم التي ارتبطت بالحديث الشريف علوم الجرح والتعديل، والرواية والدراية، ومصطلح الحديث، وطرق تصنيف كتب الحديث إلخ. . . كما تطلبت سور القرآن الكريم والأحاديث الشريفة الاهتمام باللغة العربية وحفظ اللسان العربي من اللحن والبيان العربي من الانحطاط، فكانت علوم النحو والصرف، وعلوم البيان والبديع، وعلوم العروض والقوافي، ومعاجم اللغة التي جمعت مفردات اللغة العربية إلخ. . . وقد اقتضت حركة المجتمع ومستجدات الحياة إصدار أحكام شرعية جديدة عليها، وتطلبت هذه الأحكام علوماً شرعية تساعد على تقنينها فانبثق علم أصول الفقه ثم علم مقاصد الشريعة ليكونا أبرز علمين كان الهدف منهما المساعدة في ضبط عملية الاجتهاد.
ساهمت حقائق القرآن والسنة التي أشرنا إليها سابقاً في توحيد عادات الأمة الإسلامية وتقاليدها في مشارق الأرض ومغاربها، وساعدت على توحيد الأذواق فيها، وشاركت في توحيد بنائها النفسي والعقلي، وأسهمت في توحيد نظرتها للأشياء المحيطة يها، وساعدت في توحيد ميزانها القيمي، وشاركت في توحيد تفسيرها لأمور ما قبل الحياة وما بعدها إلخ. . . كما ساعدت العلوم التي ارتبطت بالقرآن الكريم والحديث الشريف واللغة العربية والتي ذكرنا بعضها في في حفظ نصوص القرآن والسنة من جهة، وفي إيجاد طريقة موحدة لاستنباط الأحكام الشرعية وتقنينها ضمن منظومة الحلال والحرام والمكروه والمندوب إلخ. . . من جهة ثانية.
أما الدعامة الثانية للوحدة الثقافية فهم العلماء والفقهاء الذين جاءوا من تعظيم الدين للعلم، وثناء القرآن على العلماء، وحض الرسول صلى الله عليه وسلم على التعلّم، واتخاذه صلى الله عليه وسلم مواقف عملية تترجم ذلك في أكثر من مناسبة كما حدث مع أسرى بدر حين جعل فداءهم تعليم الكتابة لعدد من المسلمين. وجاءت من وجود أوقاف غنية تنفق على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى دور العلم وعلى نسخ الكتب وعلى إنشاء المكتبات العامة، وقد قام العلماء والفقهاء بحراسة وحدة الأمة الثقافية وتحصينها والسهر عليها وإيجاد اللحمة الثقافية التي تدعم الوحدة وتنمّيها وتوسّع ساحتها.
لكن وحدة الأمة تتعرض الآن إلى أخطر تهديد على مدار القرون الماضية جميعها، وهذا التهديد جاء من الكيانات القطرية التي تسعى إلى تأسيس ثقافي مستقل بها، مما سيؤدي إلى تقسيم الأمة الواحدة إلى أمم متعددة مختلفة، ولكن هذا التأسيس الثقافي للقطرية مرّ بمرحلتين:
الأولى: مرحلة تقسيم الأمة الواحدة إلى أمتين:
عربية وتركية وقد جاء ذلك على يد دولة الاتحاد والترقي في عام 1908م من الجهة التركية وعلى يد الثورة العربية الكبرى عام 1916م من الجهة العربية، ولم تستطع الثورة العربية أن تجمعّ ما كان متفرقاً، بل فرّقت ما كان مجموعاً في اتفاقية سايكس-بيكو وغيرها.
ثم جاء التنظير القومي على يد ساطع الحصري ليرسّخ القطرية ليس لأنه أراد ذلك، بل لأنه جعل الأمة تقوم على عنصري اللغة والتاريخ واستبعد الدين من عناصر تكوين الأمة، وهو في ذلك كان متابعاً النظرية الألمانية، ولكنه نسي أننا لا نستطيع أن نفهم واقع الأمة التي تقطن العالم العربي إلا بالإسلام لأن الإسلام دخل كل تفصيل حياتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخ. . .
وأننا إذا أردنا أن ننتقل بهذه الأمة من واقع التجزئة إلى الوحدة فلابدّ من الاعتراف بدور الإسلام في بناء الأمة وتفعيل عناصره، وهو ما لم تقم به القيادات القومية فكان بروز القطرية وترسخها، وصار الظن عند عامة الناس بأن التجزئة هي الأصل والوحدة هي الطارئة، مع أن العكس هو الصحيح.
الثانية: مرحلة التأسيس الثقافي المستقل لكل قطر:
اتخذ دعاة القطرية عدم التقدم باتجاه الوحدة خلال القرن الماضي حجة من أجل اعتبار الوحدة خيالاً ووهماً، واتخذوا ذلك أيضاً ذريعة من أجل الترويج للقطرية والتأسيس الثقافي لها والذي تجلّى في عدة عوامل، منها:
طباعة كتب المؤرخين الذين تناولوا تاريخ القطر، وإبراز الرحالة الذين مرّوا به وكتبوا عنه، وتعظيم رموز الأدب والشعر المرتبطين به، وتزكية تاريخه السابق على الإسلام كالتاريخ الفرعوني والبابلي والكلداني والآشوري والبربري والسيرياني والفينيقي وإنشاء مراكز ومؤسسات ترعى ذلك التاريخ إلخ. . .
ويرافق كل ذلك الاهتمام باللغة العامية والاهتمام بالشعر الشعبي والترويج لشعرائه ودواوينهم، والاهتمام بالعادات والتقاليد والفولكوز الشعبي الخاص بذلك القطر وإنشاء المتاحف الخاصة به إلخ..
ليس من شك بأن هذا التأسيس الثقافي المستقل لكل قطر على حدة يتقاطع مع الوحدة الثقافية التي عرفتها الأمة على مدار تاريخها السابق، وهو في حال استمراره ونجاحه فإنه سيؤدي إلى أخطر ما واجهته أمتنا على مدار تاريخها السابق وهو تحويل الأمة الواحدة إلى أمم متعددة.