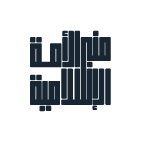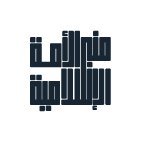قراءة في سيرة حسن البنّا رحمه الله تعالى

وُلد حسن البنّا عام 1906 في قرية محمودية البحيرة، وتعلّم في مدرسة الرشاد الدينية، ثم انتقل إلى المدرسة الإعدادية، وحفظ البنا نصف القرآن الكريم أثناء وجوده في مدرسة الرشاد الدينية، وحفظ نصفه الآخر بعد انتقاله إلى المدرسة الإعدادية، ثم انتقل إلى مدرسة المعلّمين الأولية بدمنهور، ولما يتم العام الرابع عشر من عمره، وقضى فيها ثلاث
سنوات ليتخرّج بعدها معلّماً ابتدائياً، ثم توجّه إلى دار العلوم في القاهرة وحصل منها على الدبلوم في عام 1927، حيث تعيّن إثر حمله هذه الشهادة مدرّساً في الاسماعيلية، أنشأ البنا جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 في الاسماعيلية، ثم انتقل إلى القاهرة عام 1932، واستشهد عندما اغتاله الملك فاروق في 12 شباط (فبراير) 1949.
لاشك أنّ البنا رجل ربّاني قدّم حياته في سبيل الإسلام، واستطاع أن يكون مؤثّراً في مسيرة الحياة الإسلامية، فاستفاد ممن قبله، وبنى عليه، فاستفاد من توجّهات محمد رشيد رضا وعبد الرحمن عزّام الإصلاحية إلخ…، لكنّ السؤال الأهمّ يبقى: ما الذي وفّق فيه حسن البنا إلى الصواب، وما الذي لم يوفّق فيه إلى الصواب؟
وفّق حسن البنا إلى الصواب في أنه توجّه إلى الإنسان المسلم منذ البداية، وتعامل معه، واعتبره الأصل في التغيير واتجه إلى إصلاحه وبنائه البناء الصحيح، ويمكن أن ندرك قيمة هذا التوجّه إذا قارنّاه بعلماء آخرين اتجهوا إلى إصلاح المؤسسات من أجل تغيير الواقع كما فعل محمد عبده عندما اتجه إلى إصلاح القضاء الشرعي ومؤسسات الأزهر التعليمية إلخ… لكنّ الثمرة كانت جذورها أكثر جدوى على الأمّة من خلال حركة البنا التي اتجهت إلى بناء الإنسان المسلم.
والأهمّ من ذلك أنّ البنا أصاب في أصول المعالجة التي توجّه بها إلى هذا الإنسان فعالج ثلاثة عناصر يقوم عليها الإنسان المسلم وهي: القلب والعقل والجسد، ويمكن أن نلمس تأكيداً لذلك في معظم رسائل البنا، فلو أخذنا رسالة التعاليم وهي أهمّ الرسائل التي يأخذ البنا البيعة عليها من المنضوين تحت لواء جماعة الإخوان، نجد أنها عالجت الجوانب الثلاثة في الإنسان المسلم وهي: القلب والعقل والجسد، ويمكن أن نجد تأكيداً لذلك عند فرز الأمور المطلوبة، فنجد أنّ بعض الأمور المطلوبة عالجت القلب والروح، وبعضها الآخر عالج العقل والتفكير، وبعضها الثالث عالج الجسد، ويمكن أن نجد الصورة التالية:
معالجة القلب: الورد اليومي من القرآن، ذكر الآخرة، أداء نوافل العبادة، صيام ثلاثة أيام كل شهر، الذكر القلبي واللساني، أداء الصلاة في أوقاتها، استصحاب نية الجهاد، تجديد التوبة إلخ…
العقل: حفظ الأحاديث، مطالعة رسائل الإخوان وجرائدهم، تكوين مكتبة خاصة، درس رسالة في أصول العقائد، ورسالة في فروع الفقه إلخ…
الجسد: الكشف الصحي، الابتعاد عن الإسراف في القهوة والشاي، الامتناع عن التدخين، العناية بالنظافة، تجنب الخمر والميسر والمفتر إلخ…
ومن الجدير بالذكر أنّ قيمة هذه المعالجة للعناصر الثلاثة يتضح عندما نقارنها بمعالجة حزب التحرير للإنسان المسلم من خلال التركيز على عنصر واحد هو عنصر الفكر، ثم ننظر إلى نتائج المعالجتين، فنجد أنّ معالجة البنا أثمرت نتائج إيجابية في مختلف مجالات حياة المسلمين الأخرى في السياسة والإعلام إلخ… في حين أنّ معالجة حزب التحرير أعطت نتائج محدودة جداً في حياة المسلمين.
ومما وفّق فيه البنا إلى الصواب أيضاً توجّهه إلى العمل الجماعي، واجتهاده في إنشاء جماعة الإخوان المسلمين، وعدم الاقتصار على الكتابة والتأليف في العلوم الإسلامية، وعدم العيش في برج عاجي، لقد أحسن في نزوله إلى الشارع، ومعايشته جماهير المسلمين، ومعاينته لأحوالهم، ومعالجته همومهم، وقد كان هذا دأب علماء الأمّة على مدار التاريخ بدءاً من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ومروراً بابن تيمية والعزّ بن عبد السلام وانتهاء بشيوخ الأزهر الذين واجهوا نابليون بونابرت عند احتلاله مصر، لأنّ العالِم المسلم لا يتعلّم الإسلام ويملأ عقله به من أجل أن يدوّن الكتب والمؤلّفات والصفحات، ولكن من أجل أن يعالج الواقع الإسلامي ويرتقي به: يأمر بالخير والطهر والفضيلة والاستقامة والعفاف إلخ…، وينهى عن الرذيلة والشرّ والانقسام إلخ…
ويمكن أن تتضح قيمة توجّه البنا إلى العمل الجماعي وآثار ذلك في حياة الأمّة عند مقارنته بشخص آخر هو محمد عبده، اتجه إلى التأليف والكتابة، وتعامل مع نخبة من المثقّفين، لكنّ حركة البنا الجماعية كانت أكثر بركة على حياة الأمّة من أعمال تلك النخبة الثقافية.
لكنّ البنا لم يوفّق إلى الصواب في بعض أحكامه على الواقع الجديد الذي عايشته مصر وهو: القومية المصرية من جهة، والديمقراطية من جهة ثانية.
أمّا بالنسبة للقومية المصرية ققد ظهر جيل بعد ثورة 1919 في مصر والتي قادها سعد زغلول يعتبر أنّ الشعب المصري يشكّل أمّة فرعونية مستقلّة، لا علاقة لها بالعرب والمسلمين إلا علاقة الجوار، وقد جاء هذا التوجّه متأثّراً بعصر القوميات الذي ساد القرن التاسع عشر في أوروبا، والقومية المصرية هي الرابطة التي حلّت محل رابطة الأخوة الإسلامية، والقومية المصرية هي أيديولوجيا حلّت محل الدين الإسلامي، فيجب أن يكون المصري ولاؤه لمصر، وحبّه لمصر، وتضحيته في سبيل مصر إلخ… وقد قاد هذا التيار في مصر معظم المفكّرين البارزين من أمثال: طه حسين وعبّاس محمود العقّاد، وتوفيق الحكيم، ومحمد حسنين هيكل، وسلاّمة موسى إلخ…
عندما تعرّض البنا إلى موضوع القومية المصرية اعتبر أنه إذا كانت القومية تعني حب القوم، والوطنية تعني حب الوطن فهذا مما يقرّه الإسلام ويعترف به، وإذا كان يعني التعصّب المقيت للقوم والوطن فهذا مما يبغضه الإسلام، وما قاله البنا صحيح، لكن القومية المطروحة في مصر آنذاك والمنقولة عن الحضارة الغربية لم تكن المعاني السابقة فقط، بل كانت تعني أنّ المصريين أمّة فرعونية، وأنّ الانتماء إلى هذه الأمّة يجب أن يكون الحقيقة الوحيدة التي يدور حولها المصري في مشاعره وأفكاره وسلوكه وتصرّفاته، وهي عقيدة ودين وأيديولوجيا يجب أن يقيم المصري عليه وجوده وكيانه، ولاشك أنّ هذا الكلام عدا أنه غير صحيح شرعاً، ليس بصحيح موضوعياً، فليس هناك أمّة فرعونية، والشعب المصري يشكّل جزءاً من الأمّة الإسلامية، وقد دخل الإسلام في كل جزئيات حياته النفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والفنية والسياسية إلخ…
وأمر آخر لم يوفّق فيه حسن البنا إلى الصواب هو تمييزه بين الدستور والقوانين، واعتباره أنّ الدستور المصري أقرب ما يكون إلى الإسلام، ولا يعدل به نظاماً آخر، واعتباره أنّ الخطأ في القوانين المخالفة للإسلام مثل القوانين التي تبيح الربا وتسمح ببيع الخمور والزنا إلخ…، لكن هذا التمييز غير صحيح لأنّ كلاً من الدستور والقوانين مرتبطان بالديمقراطية التي هي مظلّة لهما، وهي الأصل الذي يتفرّعان عنها، والحقيقة أنّ المخالفات الشرعية التي برزت في الحياة المصرية والتي تجسّدت في القوانين المصرية، إنما جاءت من الديمقراطية التي أفرزت الدستور والقوانين، وبخاصة جاءت من الجانب الفلسفي في الديمقراطية، لأنّ الديمقراطية ذات حالتين: الفلسفة وهو الأهم والثابت، والآليات وهي الأقل أهمية من مثل إجراء الانتخابات وإقامة الأحزاب إلخ…، والفلسفة في الديمقراطية تقوم على نسبية الحقيقة، أي أنه ليست هناك حقيقة مطلقة، وأنّ كل شيء قابل للتغيير، لذلك يمكن أن يكون الربا والزنا حراماً في نظر الديمقراطية ثم يصبح حلالاً أو العكس، لأنّ الحقيقة نسبية في نظرها، في حين أنّ هناك بعض الحقائق الثابتة لا تتغيّر في ديننا إلى قيام الساعة من أمثال: حرمة الزنا والربا، وكون الظهر أربع ركعات، ووجوب الصيام في رمضان إلخ… وهذه الحقائق الثابتة مرتبطة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
من الطبيعي أن يوفّق البنا إلى الصواب في بعض الاجتهادات، وأن لا يوفّق إلى الصواب في بعضها الآخر، فهذا أمر طبيعي في البشر، لكنّ الأهمّ من ذلك، أنه حفر مجرى فيه خير كثير، ويفترض فيمن يأتي بعده أن يبني على الصواب الذي وفّق إليه البنا، ويبتعد عن الخطأ الذي لم يوفّق فيه، وهذا ما حدث فعلاً، فقد أغنى عدد من المفكّرين والكتّاب الإسلاميين الصواب الذي تركه البنا من أمثال: عبد القادر عودة، وسيد سابق، وسيد قطب، ومحمد قطب إلخ…، وهذا من المبشّرات التي تدعو إلى التفاؤل وإلى الاطمئنان إلى أنّ مسيرة العمل الإسلامي تتجه في الاتجاه السليم، وبأنّ اللاحق يبنى على صواب السابق.
Lorem Ipsum